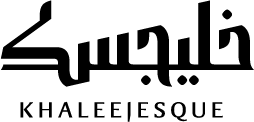قد يبدو السفر إلى أرض مجهولةٍ فكرة تفتح ذراعيها إغراء لكُلّ الحالمين والمُفعمين بروح المُغامرة، لا سيما أولئك الذين عاشوا عمراً رتيباً وبدايات شباب بلا مذاق خاص، لكن خوض التجربة لها حسابات أخرى قد تكسرك تماما قبل أن تكون مؤهلا للدفاع عن أحاسيسك أمام ضربات الوجع، وقد تملأك بقوّة خرافية تصيّرك أقوى من الشخص الذي كُنته قبل خوضها، فينبت لك جناحين مؤهلين لتحدي المستقبل بثقة هائلة، وأملٍ كبير، وشجاعة بلا حدود. وهو ما حدث لي خلال الأعوام القليلة الماضية، يوم خبزتني الأحداث والأيّام وعجنت شخصيّتي لتصنع مني الإنسانة التي صرتها اليوم. ولأن حكايتي هي حكاية كل شابة أو شاب خليجي يغادر وطنه للتحليق في عالم جديد قد تكون نقطة بدايته الدراسة، أو حتى العمل، أحكيها لكم اليوم ليرى بعضكم فيها صورته الماضية، ويتصوّر بها بعضكم الآخر ما قد تكون عليه صورته المستقبلية.
بدأت الحكاية عندما إنتقلت من موطني الأم "السعودية" إلى موطني الذي أعتبره "خالتي" الصغرى "البحرين" لإتمام دراستي الجامعية. ورغم أنني بدأت دراستي في السعودية فعلياً لما يزيد عن عامين تقريباً، إلا أن شخصيتي ظلت تتمتع بطراوتها الأولى، لا سيما وأن الفرق بين الحياة الإجتماعية داخل القطاع الشرقي من السعودية، حيث ولدت وعشت، تختلف تماما في المكان الذي إنتقلت إليه فجأة، الأمر الذي لم يعصمني من التعرض لصدمة المواجهة الأولى مع الفرق بين المجتمعين. وكم كنت أشعر خلال الشهور الأولى من حياتي الجامعية والإنسانية في المنامة أنني قد خرجت من حياتي الواقعية لأدخل لحياة داخل برنامج تلفازي شيق أو مسلسل مغامرات يضج بالأحداث و الألوان. بدا لي أن للبحر رائحة مختلفة، ولأرواح الناس -على تباينها- تركيبة مختلفة، وللغيوم والرياح والأمطار شكل مختلف، لكن الدفء الأسري الخليجي المحفوف بعادات وتقاليد أصيلة في كل شبر من أرض الخليج لا يتغير ابداً، ولا يقل، ولا ينقص، ومن هذا الدفء يستمد المواطن القادم من بقعة خليجيّة إلى أختها مقدرته على الصّمود في وجه الشوق إلى الأسرة، و ذكرياته مع الوطن الأوّل.
تجارب جديدة
كان من أهم التجارب التي خضتها في تلك الفترة تجربة إكتشاف الآخرين، وسبر أغوار تضاريسهم الرّوحيّة، والتعرّف إلى صديقات وأصدقاء جُدد من مختلف دول التعاون الخليجي. تعلمت الإعتماد التام على الذات، وإكتشفت حين نلت فرصة الإختلاط العلمي والإجتماعي بزملاء من الشبّان الخليجيين مدى طيبة وشهامة معظم أولئك الشبان قياساً إلى الفكرة الخاطئة التي تكرسها بعض الأفكار القديمة عنهم، فتربيتهم الأسرية القائمة على احترام الآخرين وتقدير العادات والتقاليد جعلت منهم إخوة ساهموا في دعمنا نحن الفتيات، ومساندتنا، وتعليمنا الكثير دون مقابل. وإكتسبت قوة هائلة في شخصيتي بعد إجتياز صعوبات ما كنت لأجتازها لو كنت في بلدي، فصرت أكثر ثقة، وأقدر على التحدث مع الآخرين دون إرتباك أو خجل يؤثر على تواصلي مع معارفي الجدد.
زرت أماكن كثيرة داخل البلد الذي أقمت فيه، وتلقيت دعوات من صديقات خليجيات لزيارتهن في أوطانهن خلال العطلات الصيفية أو بعد التخرج، ولطالما عاملنني والدات صديقاتي اللواتي يأتين لزيارتهن من بلدانهن معاملة لا تقل عن معاملة والدتي الحبيبة في اللطف والنصيحة. كما اكتشفت أن في أرض الخليج طاقات علمية وإبداعية تكاد تبلغ حدود العبقرية، لكن إحساسها الرفيع، وتواضعها الإنساني، وضميرها المتيقظ، حرمها من أن تكون تحت دائرة الضوء العالمي الذي تستحقه.
لكل تجربة صعوباتها
مضت أيّام الدراسة الجامعيّة بحلوها ومرها، واكتشفت أن لي رغبة في التخلص من قيد تخصصي العلمي الذي فرضته علي الظروف كي أحقق حلم طفولتي الكبير بأن أغدو إعلاميّة مشهورة، أو مذيعة متألقة. ولم يكن أمامي حينها غير إتمام دراساتي العليا "الماجستير" في تخصص الإعلام والعلاقات العامّة. ولأن خياري الجديد كان على مسؤوليتي الشخصية، ولأنه كان يتطلب البقاء لفترة أطول في البحرين لتوفر ذاك التخصص هناك أولا، ولأن بيئتها الإعلامية والفنية والمجتمعية أكثر قابلية لصناعة المبدعين والإعلاميين، فقد قررت أن أعتمد على نفسي في توفير الشطر الأكبر من تكاليف إقامتي ودراستي، الأمر الذي تطلب مني البحث عن عمل ملائم في البحرين ولو لبضع شهور قبل أن أقدم أوراقي إلى الجامعة مجدداً. وشاء الله أن أجد العمل بعد بحث طويل ودعاء مخلص، وكانت تلك تجربة أخرى، وعالم جديد من الاكتشافات الموجعة.
كانت الشركة الخاصة التي عملت فيها تحت إدارة قبرصية، ولا أبالغ مطلقاً إن قلت أن تسع وتسعين بالمائة من موظفيها هم من العمالة الآسيوية الوافدة، وكان صاحب الشركة -الذي هو مديرها القبرصي- يبذل ما بوسعه للتهرب الغير مشروع من قوانين وزارة العمل البحرينية على إختلافها، وعدم دفع أجور العمال والموظفين، كما كان الموظفون الشرق آسيويون يهيمنون على مجتمع الشركة ويحاولون إيذاء أي موظف بحريني أو خليجي مستجد كي يترك العمل، فيثبتوا بذلك لرئيسهم نظرية أنهم "الأفضل" على جميع الأصعدة. وفوق كل هذا كان الأجر قليلا جدا، لا يكفي تكاليف المسكن وحده. وهكذا وجدت نفسي أنهار باكية في حجرتي ذات ليلة في حالة تقترب من اليأس أمام شبه استحالة تحقيق الحلم. فمادمت أعجز عن توفير تكاليف مسكني، وطعامي، وأبسط احتياجاتي البشرية كإنسانة وفتاة، كيف سأكمل دراستي وأخوض الغمار الإعلامي وأغدو مذيعة يصفق لها الجمهور؟ لن يكون بوسعي أن أكون مثل الشهيرة "أوبرا وينفري" أو المتألقة "بروين حبيب" أو البراقة "حليمة بولند".
لكنني سرعان ما جففت دموعي، وقررت أن أهب نفسي فرصة جديدة ولو لبضع شهور قبل أن أستسلم تماما. وقلت لنفسي: "مادام أولئك القادمون من شرق آسيا يستحقون الصبر والصموت وتحقيق ما يشبه المعجزات في بلدانا، فكيف لا أستطيع أنا تدبر شؤون حياتي على أرض أهلها أهلي، ولغتها لغتي، وتاريخها أنا منه وهو مني؟! يجب أن أبذل أقصى ما بوسعي، ولا شك أن الرب لن يتخلى عني"
وحاولت، وبدأت أنجح بالفعل، ولهذا حكاية أخرى يطول شرحها، قد أحكيها لهم ذات يوم.
– زينب علي البحراني