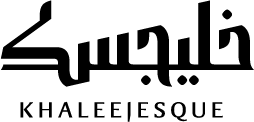الكتاب بأوراقه وملمسه ورائحته التي تعبق في زواريب المكتبة المنزلية، إذ يتخيّل إليك إنه منذ وقت طويل، وخصوصاً بعد أن أدخلت مواقع الشبكة العنكبوتية وحشرت نفسها في حياتنا، لم يعد له ذلك الألق كما كان.
وفي هذه الأحيان، نتذكر جيداً "يوحنا غوتنبرغ" صاحب أول مطبعة في العالم، حيث إنكلترا وترجمة الكتاب المقدس كأول كتاب يُطبع بعد سلسلة مخاضات مرّ بها العالم البشري فيما يُعرف باسم ثورات الاتصال البشرية، حيث جاءت مرحلة الطباعة بعد مراحل من الرموز والإشارات والكلام والكتابة ثم الطباعة فثورات الاتصال، تلك الطفرة التي اجتاحتنا منذ ثمانينيات القرن العشرين إلى هذه اللحظة.
وبعد أن أصدرت منظمة "اليونسكو" أرقامها المفزعة عن القراءة وعلاقة القارئ العربي بالكتاب، والتي أكدت أن "معدل القراءة في العالم العربي لا يتجاوز 4% من بريطانيا، فمجموع استهلاك الدول العربية من مستلزمات الطباعة أقل من استهلاك دار نشر فرنسية واحدة هي دار غاليمار". وليس هذا فحسب، بل "لكل 12 ألف مواطن عربي كتاب واحد، على عكس بريطاني مثلاً، لكل 500 منهم كتاب"، حتى إن العالم العربي لم يقدم للإنتاج العالمي ما يُذكر رغم أن التاريخ كان عكس ذلك. تعود الإحصائيات إلى عام 2008.
منذ تلك اللحظة وثمة الكثير من الغبن وحتى التشاؤم يلف مصير الكتاب، وربما يعرف القلائل فقط أن 12 نيسان هو اليوم العالمي للكتاب. المشكلة يتحملها القرّاء أيضاً، حتى أن "يونغ" صنّف القرّاء إلى أربعة أنواع هم: النصي والمدرب والنهم والعليم.
يُقال إن مواقع التواصل الاجتماعي إذاً أطلقت العنان لمن يريد أن يعبر عما في نفسه ومن كافة الأطياف والفئات، لذا كان من المطلوب أن يحدد الشخص علاقته المنسية أصلاً مع الكتاب، وهل هي تعاني بالفعل من ضمور أم أن الكتاب بحد ذاته لم يعد له تلك الأهمية؟
رغم ذلك، فالكتاب لا يزال يعاني من ارتفاع أسعاره، كونه من الورق، والورق غالٍ، ثم إن دور النشر، كالعادة، تبرر قلة نشرها الكتب في عدم وجود أو انعدام عدد قراء الكتاب نسبة إلى ثلاثين أو أربعين سنة مضت، كما أن العديد من القرّاء اتجهوا إلى قراءة الكتب إلكترونياً عبر الحاسوب المحمول أو حتى أجهزة الخليوي بكل أنواعها، لكن في المقابل نرى المكاتب تعج بالكتب، وبنظرة سريعة عليها، نلاحظ أن النسبة الغالبة منها تنحصر في كتب الفلك والمطبخ والبرمجة اللغوية العصبية وغيرها من الكتب الدينية، مع تهميش واضح للكتب الأدبية والثقافية والمعرفية والفلسفية، مهد صناعة الكتاب وروحها.
في هذه الأثناء، كما هو حال العائلة عندما تحاول التخلص من أثاث منزلها، تحاول التخلص من الكتب، وخاصة إذا مات صاحبها، ولم يعد هناك من يهتم بها، فتقوم العائلة، بحجة أن الكتب وأوراق الصحف تجلب الصراصير، ببيعها إلى أقرب شخص يبيعها بدوره على مكتبات الرصيف التي تزخر العديد من العواصم العربية والعالمية بها.
لكن ما أقوله لا يُقلل أبداً من دور معارض الكتب التي تُقام وتستقطب آلاف المهتمين ممن يدونون أسماء الكتب التي يريدونها والبحث عنها ضمن هذه المنظومة، حتى يصل الأمر بهم إلى شرائها بأي ثمن كانت، فالمهم أن يكون الكتاب المطلوب وحسب.
لذا، تبقى القراءة عبر أجهزة الحاسوب غير مجدية في نظر الكثيرين رغم أنها مفيدة جداً في أحايين عدة، فالكتاب غير المتوفر في الأسواق أو الممنوع موجود على الإنترنت، ولاسيما إذا كان ثمنه مرتفعاً، كما أن الحجم الذي تستهلكه هذه الكتب في العالم الافتراضي لا يُقدر بصغره، فذاك أفضل من مكتبة متنقلة على الظهر كما يُقال، في حين أن بُعد المسافات يلتهمها المجتمع الافتراضي، وتستطيع بالتالي حفظ آلاف الكتب في قرص ليزري واحد.
من يقرأ الكتب؟ من لا يقرؤها؟ نحن بالطبع نحن ولا نقرأ.. فالمواطن البريطاني، على سبيل المثال، أصبحت القراءة من عاداته اليومية، فهو بمثابة الخبز اليومي ووجبات الطعام الرئيسة، فانتشرت ظاهرة كتب الجيب، خفيفة الحمل وسهلة الاستخدام والقراءة في محطات المترو أو الطريق أو حتى في انتظار عيادة الطبيب.
إذا أردنا للمجتمع أن يتطور، يجب أن نطلب منه القراءة، هذه الأمثولة المختصرة لكل فلسفات العالم التي يختصرها المفكرون بدورهم عبر فلسفاتهم عن المجتمع البشري. فمن حيث كان للكتاب معنى، كان للمجتمع قيمة.
الآن نحن بصدد القراءة في المجتمع العربي إذاً، وبين القراءة والقارئ الكثير الكثير من الحلقات المفقودة، فالشاعر الذي سيطبع ديواناً أو مجموعة شعرية الآن لن يلاقي التشجيع والقبول، فالموضوع تراكم وليس فوري، أي أن تجارة الكتب، إن جاز القول، تبحث عن الربح ومدير دار النشر يعلم مسبقاً أن الموضوع غير مجدٍ اقتصادياً، والكثير من هؤلاء الكتّاب يدفعون من جيبهم الخاص ثمن طباعة كتبهم، فالمهم أن يُنشر، هذا إذا استثنينا موضوع الرقابة والقيود السياسية والفكرية وتابوهات المجتمع المتمثلة في السياسة والجنس والدين.
يكفي القول إن القراءة تسهم في تحضير وتطور المجتمعات وتمنحها هوية وخصوصية وقوة، فضلاً عن أنها مفتاح لكافة المعلومات، واستكشاف الآخرين، بالإضافة إلى تطوير الأفكار والذات، فهذا العصر هو عصر المعلومات، وما يلزمه هو سلاح المعلومات. لذا، يبقى للكتاب ألقه رغم كل المنافسين، هؤلاء المنافسين يمنحون الكتاب الصدارة بحد ذاته، ولعل من أكثر الأسئلة التي يجب أن نواجه بها أنفسنا هي من مثل: ما اسم آخر كتاب قرأتُه؟ وماذا استخلصتُ منه؟ منذ متى قرأتُ آخر كتاب؟
– آلجي حسين