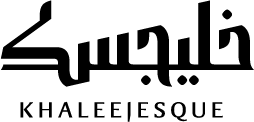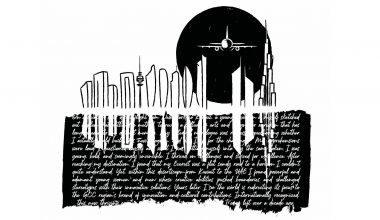محمد حافظ، المهندس المعمـاري والفنـان الناشط
لسخطهم من النّظام – في ٢٠١١ – اعتُقل طلاب مدرسة يبلغون من العمر خمسة عشر عاما من مدينة درعا السّوريّة بعد أنْ رسموا على ممتلكات المدرسة شعار الرّبيع العربي المُجلجل، والثّائر: "الشّعب يُريد إسقاط النّظام". اعتُقل الفتية، ومن ثمّ أطلق سراحهُم. في مارس ٢٠١١، أطلق النّظام الرّصاص على المُتظاهرين في درعا، مشيرا إلى استمرار الثّورة السّورية. ونتج عن الحرب الأهليّة عزل السّوريين السّاعين للهجرة.١ ومع توسّع الشّتات، برزت استجابة نشطة لجماعة من الفنّانين المهاجرين السّوريين واللاجئين كرد فعل على الجرائم السّافرة، فعبّروا عن بغضهم الشّديد للحرب في منجزاتهم.
من بين الفارين من الحرب الذين تميزت رحلتهم، الفنان والمعماري محمّد حافظ، المولود في دمشق، والمقيم حاليا في نيوهافن، كونيتيكت (الولايات المتحدة)، يُعرف حافظ بما يُطلق هو عليه: "منحوتات شخصية"، وهي مجسّمات شبه حقيقية مُصغّرة للمناطق المدنيّة السّورية – من التصميم الداخلي للمنازل الخاصّة إلى التّصميم الخارجي للأحياء الدّمشقية القديمة. منحوتات حافظ تطورت مع تفاقم وتيرة الحرب الأهليّة. ومع بروز انتهاكات الحرب، نقلت منحوتاته بشكل مكافئ الذكريات السّورية بإسهاب لحياة الوطن قبل الأزمة من خلال إتقانه للمهارات المعمارية. عُرضت أعماله الفنيّة في منصات فنيّة عالميّة شهيرة، كما عُرف منذ عام ٢٠١٨ بانتسابه للزمالة في كليّة سيليمان التّابعة لجامعة ييل.

من بين الفارين من الحرب الذين تميزت رحلتهم، الفنان والمعماري محمّد حافظ، المولود في دمشق، والمقيم حاليا في نيوهافن، كونيتيكت (الولايات المتحدة)، يُعرف حافظ بما يُطلق هو عليه: "منحوتات شخصية"، وهي مجسّمات شبه حقيقية مُصغّرة للمناطق المدنيّة السّورية – من التصميم الداخلي للمنازل الخاصّة إلى التّصميم الخارجي للأحياء الدّمشقية القديمة. منحوتات حافظ تطورت مع تفاقم وتيرة الحرب الأهليّة. ومع بروز انتهاكات الحرب، نقلت منحوتاته بشكل مكافئ الذكريات السّورية بإسهاب لحياة الوطن قبل الأزمة من خلال إتقانه للمهارات المعمارية. عُرضت أعماله الفنيّة في منصات فنيّة عالميّة شهيرة، كما عُرف منذ عام ٢٠١٨ بانتسابه للزمالة في كليّة سيليمان التّابعة لجامعة ييل.
من غرفة فندقه ، غير بعيد عن جامعة كورنيل حيث يقام معرضه الأخير، يجيب حافظ على أسئلتي حول الفن ، وشدة الحنين إلى الماضي ، ودمشق القديمة ، وأزمة اللاجئين.
البدايات
ملاك السّويحل: سنة ١٩٨٤
وُلدت في دمشق، سوريا. وبعد فترة قصيرة، انتقلت أسرتك للإقامة في الرّياض. حين كنت تبلغ من العمر شهرا واحدا. فما هو دافع أسرتك للانتقال الطويل من الوطن بصحبة طفل في مهده؟
محمّد حافظ: درس والدي، وهو جراح متقاعد، مع أسرتي في ألمانيا قبل ولادتي. في ذلك الوقت، في أواخر السبعينيات، كانت هناك موجات من الحركات الوطنية النّاشئة بين مجتمع المهاجرين العربي. أوقدت وأثارت روح الجماعة تلك الحركات، فتطلّع والدي إلى العودة للعالم العربي كي يخدم وطنه الأم. حزمنا حقائبنا وعدنا إلى دمشق. ولسوء الحظ – مع مطلع الثمانينيات – كان وقت اضطراب في السياسة السّورية – وحصلت هجمات تفجيريّة، وتجاوزات في استخدام السلاح.
أدرك والدي حينها أن قرار العودة لم يكن قرارا صائبا. ومن هناك، بدأ يبحث عن وظيفة خارج الحدود السّورية. حينها – بعد ولادتي – انتقلنا إلى المدينة، في المملكة العربية السعودية. وبعد عام أو عاميْن، حصل والدي على فرصة عمل في مشفى عسكري، له فرعين، أحدهما في الرّياض، والآخر في الخرج (جنوب الرّياض). كان والدي رئيس قسم الجراحة في الخرج.
م.س.: أقمت في المملكة المتحدة خمسة عشر عاما، في مُجمع سكني مخصص للبريطانيين، والأمريكيين، والأطباء العرب من مختلف الجنسيات. ذكرت أنّك لم تتأقلم اجتماعيا مع السعوديين وبقية الجنسيات. ولم تختبر الحياة في المملكة خارج المجمع كثيرا. كيف كانت تلك المرحلة من حياتك؟ هل أجّجتْ مشاعر التّغرب أم شعورا بالاحتواء؟
م.ح.: المجمع السّكني الذي أقمنا فيه في الخرج كان سكنا متوسطا للأطباء. في الثمانينيات، والتسعينيات، كانت الخرج مدينة صغيرة المساحة، وبسيطة، وكذلك هو الحال مع قطاع التّعليم. أراد والدي أفضل تعليم لي ولأشقائي، ولهذا السّبب، تحولنا لاستخدام حافلة تنقلنا لساعة ونصف يوميا من الخرج إلى مدرسة خاصّة في الرّياض. كنّا نستيقظ مع بزوغ الفجر، ونعود بعد تناول والدَي لطعام الغداء. امتحنت تلك التّجربة صبري، وكانت بمثابة دَرسٍ آتى ثماره. تلقينا تعليما محكما. غير أنّ انزوائي لا يتعلّق بالأنظمة.
إضافة لذلك، كانت مساحة المجمع السكني هائلة، ضمّ ٢٠٠ أسرة – مما يعني أنه لم يكن هناك نقص في الرّفاق، وكان المجمّع أشبه بفقاعة. لم أضمر مشاعر مستشرية للعزلة. أدرك أنّه على الأوراق يبدو أنّي قد علقت في مجمع سكني حماني من السّكان المحليين. لكن على على العكس تماما، في ذهني ذكريات سعيدة، مطمئنة، وهادئة عن نشأتي في السعودية. في الواقع، في المدرسة (في الرّياض)، كان لدي رفاق ينتمون لأسر سعودية الجنسية، وكانوا عزيزي على قلبي. وبلا شك، فإنّ انطباعي، وتجربتي تخصّاني ولا تنفيان شعور الاغتراب لدى من شعروا به هناك.
حينذاك، لم يكن للجمهورية السورية وجود على خارطتي، لأتحدث عنها. اعتدنا على السفر إليها خلال إجازة الصيف لزيارة أسرتي وأصدقائي في دمشق. حقيقة، لم أفهم بعمق الوطنية، وثقافتي، وجذوري التاريخية، ووطني الأم. كنتُ مجرّد طفل قد سّلم بكل المعطيات. أمّا من ناحية الهُويّة، فأجدني نصف " كيان إنسان خليجي"، بسبب الذكريات العاطفية التي أكنَنْتُها للسعوديين في التسعينيات.
البلوغ، والهُويّة، والعودة إلى دمشق العتيقة
م.س.: نحن الآن في عام ١٩٩٩
بعد عودتك لدمشق العتيقة، وصفت عودتك للوطن بأنه وقتٌ لإعادة الاستكشاف – استكشاف لجذورك، من أنت، ومن أين أتت. هل لك أن تستذكر ذكريات العودة تلك – على كلا الصّعيدين الرّوحي والعاطفي وأنت يافع؟
م.ح.: عدت لدمشق وأنا في الخامسة عشر من عمري، وكانت المرة الأولى في حياتي التي أدرك فيها بحثي الواعي عن هُويّة – من أنا، انتمائي، جذوري العائلية، كانت زيارتي الأولى لدمشق القديمة. أتذكر المشي مع أسرتي واستشعاري لهيبة البنيان الأثري – المسجد الأموي، المعمار الرّوماني، والكنائس، والمساجد القديمة، والشّوارع، وواجهات المتاجر المكتظة بالمتسوقين، والمقاهي المزدحمة بروّادها.
لم أحظ بهذه التّجربة البصرية من قبل. أصفها على أنّها "احتفاء بالحياة"، وتعايش متجانس لأعراق وأديان كثيرة في بقعة جغرافية واحدة. من مبانيها الجميل، تكون لدي عشق لنسيج دمشق الاجتماعي المتنوع. وبما أنّي معماري، فقد كان أبرز اتصال بالمدينة قد نشأ من تجاور المساجد والكنائس التي ترجع لقرون سابقة، مما يدل على أنّ مفهوم التّسامح كان موجودا قبل تشييد هذه الصّروح المعمارية. أعلم أنّ كلماتي المتعلقة بالسلام والتّعايش قد تبدو مبتذلة أو تافهة، لكن الأجيال الحديثة أكثر تآلفا مع واقع الحرب المُسيّس، والطّائفية، و القبلية، والتمييز العرقي السّافر الذي استمر في سوريا ولبنان. كيف تقنع جيلا قد لا يتذكر الحال قبل الأزمة السّورية، بوجود تاريخ سلمي سبق الانقسامات الطاحنة؟
أمنيتي الرّاسخة إيقاظ مشاعر هذا الوعي. فكرة التعاطف هذه تعمّق تعمّق عملي – أمل مسبق بأنّ المنصات الفنيّة تدفع باتّجاه التطور في المستقبل القريب. دور الفن العربي عند هذه المرحلة هو تقريب الأجيال الحالية من إرثهم التاريخي. نخسر معرفتنا بتاريخنا كعرب، إذا سلّمنا بأنّ الثقافة العربية والمُسلمة عنيفة، ثم إنّ هكذا تعبيرات يمحوها التعميم. أخبر أقراني هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، أنّ الفنّانين يوثقون أزمانهم، ولهذا يجب أن تعكس أعمالهم الأحوال المعاصرة لهم. لا ضير في رسم الزّهور الصامتة، لكنّي هذا ليس مكاني في التاريخ. سيرسم مئات الفنانين الزّهور، لكن كم شخصا فنانا عربيا ومسلما سيكرس حياته لردم الهُوّة بين الشّعوب وتحفيز التواصل بين الشّرق والغرب، في وقت تزايد فيه رُهاب الأجانب وبغضهم. كثير منا (الفنانون العرب) يقيمون في الغرب، وبهذا يصبح من واجبنا، ويندرج ضمن مسؤولياتنا ضمان إنتاج فن ملائم، و ذو معنى.

التعليم، الوظيفة .. أمريكا
م.س.: ذكرت في وسائل إعلام عديدة أن أسرتك قد واجهت ما وصفته بـ"هجرة قسرية" حدث في ثلاثة أوقات متباعدة خلال حياتك. دون الخلط بين الهجرة واللجوء، ومع الأخذ بالاعتبار الظروف المحزنة الحالية للجمهورية السورية، هل يمكنك أن تصحبنا في رحلة (هجرتك)؟
م.ح.: فيما يخص (الهجرة القسرية) التي عايشتها حينما سافرت أول مرّة لدراسة العمارة. قُبلت بداية في جامعة دمشق، لكن لم أُقبل في تخصص العمارة كما خططت مسبقا – رغم معدلي التراكمي العالي. وبعد أربعة أعوام من الإقامة في سوريا، وجدتني في جامعة ولاية أيوا مع سمة دخول (فيزا). صالحة لمرة واحدة. تزامن ذلك مع أحداث ١١ سبتمبر، كان عصيا على أي عربي ومسلم دخول ومغادرة الولايات المتحدة بيسر، نظرا للرقابة المتصاعدة. كان أأمن خيار بالنّسبة لي هو العدول عن مغادرة الولايات المتحدة. لم أشاهد أفراد أسرتي ثمانية أعوام. ولّدت هذه "الإقامة الجبرية" شوقا وحنينا عارما لوطني الأم. وتنامى عشقي لسوريا، وندمت لأني لم أتعرف عليها بشكل أفضل – خاصة تلك المساحات التي دمرتها الحرب.
على أي حال، حينما يغادر المرء موطنه أو إقليمه فإنه يكابد شعورا متزايدا من الحنين. هذا الحنين هو النسيج المتصل الذي يثري عملي الفني. "الحنين" برأيي، وعلى اعتبار أني معماري، متصل و مرتبط بإحساس بالمكان. ولهذا السبب، قد يقدر عملي جمهور أكبر ليس بالضرورة أن يكون عربيا أو سوريا، سبب هذا، أن عملي يلامس إدراكنا الإنساني الجمعي لتتوق لمكان وزمان محددين – الوطن. عنصر الحنين هذا في عملي هو أيضا ألماني، وأوروبي، وتعبير عالمي عن للحيات في شتات. تأتي العزلة من تجربتنا الإنسانية المشتركة بالنّزوح عن أو مغادرة أوطاننا سعيا لحياة كريمة في مكان آخر. قرار مصيري صعب.
لأنّي وأسرتي آمنين، أستشعر هذه النعمة. ولهذا، أنا كمسلم، عربي، معماري، وفنان سوري يعيش في الشتات، تقع على عاتقي مسؤولية توجيه انتباه العالم لأولئك العاجزين عن الفرار من جحيم الحرب. وبرأيي، تصاحب هذه النّعمة مسؤولية عظيمة: استخدام الفنان لمنصة تعرض أعمالهو، ليتواصل مع الجمهور الغربي بُغية تضخيم أصوات من لاقوا الويلات.
م.س.: نحن الآن في ٢٠٠٣.
إذن، فقد انتقلت من سوريا لمتابعة دراستك في الولايات المتحدة. من هناك، انتقلت وتقيم حاليا في نيوهافن، كونيكتكت لتواصل عملك في العمارة. ماذا شعرت عندما انفصلت و تم اعادتك الى الشتات مرة أخرى؟ ولماذا نيوهافن تحديدا؟
م.ح.: لا يوجد سبب واضح للانتقال إلى نيوهافن. إنها مكان جميل بين بوسطن ونيويورك. أي أنها سهلة، وقريبة من الشاطئ. سبب عملي في نيوهافن هو أنّ پيكارد چيلتون [قطاع معماري] قد وظفوني، و أرادوني أن أنتقل إلى ولاية أيوا، ففعلت، وهذا ارتباطي بهم. إضافة لذلك، وجدت تقربي منهم ضروريا، فأسست علاقات وديّة مع عدد من الجامعات والكليات البارزة؛ فأنا أعتبر عملي تعليميا أكثر من كونه تجاريا يعرض في المعارض، أجد أنّ وجود مساحة تشجع على أكثر على الحوار في مؤسسة تعليمية عليا يناسبني أكثر.
عمل فنّي- قصيدة لسوريّا
م.س.: أنت فنان متمكن ومنجز، كما أنك مهندس معماري. هلا حدّثتنا أكثر عن هن هذين المجاليْن وتداخل التعريفات واندماجها، من خلال تجربتك؟ مهاراتك البارعة حاضرة حينما تصنع منحوتات مصغرة تشبه الواقع، فهل تعتبر نفسك فنانا متعدد الاختصاصات؟
م.ح.: من وجهة نظري، لا يمكن للبشر أن يهتموا بمجال واحد فقط. لسوء الحظ، أكثر مشكلة جسيمة أواجهها في أنظمتنا التّعليمية اليوم هي أنّها تعد التّلامذة لوظيفة، ومهارة، ونمط عمل واحد – على سبيل المثال: إذا درستَ الطّب، فلن تكون إلّا طبيبا. رغم أن النّاس في الماضي قد أهلوا أنفسهم لأكثر من وظيفة، واكتسبوا مجموعة مهارات. الفنان البصري كان عالما أيضا، وطبيبا، وفلكيّا، وشاعرا ["إنسان عصر النّهضة"]. إنّها طبيعة الإنسان التي تدفعه لأن يكون متحمسا، و فضوليا بشأن كل شيء! في حالتي، فإنّ عملي كمعماري ومهاراتي الممارسة كفنان لا يتصادمان؛ كلا الممارستين مفيدتان.
استُلهمت أعمالي الفنيّة [مصغرات حضرية] بوضوح من مهاراتي كمعماري. ولأننا بشر، فنحن معقدون. هذا التعقيد في صميمنا ولا يمكن حصره بمهارة أو عمل واحد. وعلى ذات المنوال، لا يمكن حصرنا بثقافة أو جنسية واحدة – لجواز أمريكي، أو جوازي سوري، أو حتى جواز كويتي فقط، إلخ. حينما يعكس فنان طبيعة الإنسان المتعددة هذه، فإنّه يبدأ في بناء الكثير من الأسس المشتركة بينهم وبين العالم. هكذا نعزز التشابه ونُصفّي أنفسنا من النّعرات القبليّة.
م.س.: في مصادر إعلامية أخرى، صرحت بالعبارة التّاليّة: "إذا لم أتمكن من العودة إلى الوطن، فسوف أعيد خلقه". هذه عبارة تنطبق على فنك، سلسلة منحوتات واقعية للمقالات القصيرة البصرية السّورية – من القطاعات السكنية إلى الأحياء الخارجية. وبينما تطور فنّك مع تصاعد الحرب، اخترت أيضا الإسهاب في تناول الذكريات السوريّة لحياة المنزل قبل الأزمة. أيمكنك أن تحدثنا أكثر عن فنّك؟
م.ح.: فيما يتعلق بوظيفتي، فإن من الأفضل أن يكون السؤال هو التّالي: كيف يُلهم الفن الهندسة المعمارية؟ ما اكتشفته من خلال تفاعلي مع الأسر اللاجئة، وأولئك الذين أجبروا على هجر أوطانهم يتشاركون رابطا حميما مع بلدانهم وجوهرها المعماري. حب المرء لمعمار بلده الأصيل يتحدد بحب النّوافذ أو شرفات ممتلئة بذكريات، وهو يطل خارجا، ويستمع لفيروز [مطربة لبنانية أسطورية ذات تأثير طاغ]، مستمتعا بنسمات الليل العليلة. حينما أضع هذا في اعتباري، أجد أنّي كمعماري، أهتم بهذه اللحظات الحميمة، وأعكسها في مشروعاتي الفنيّة، وبالتالي تتجاوز التطبيقات العملية الحاذقة للتصميم المعماري. و لصنع ذكريات لا يمكن نسيانها لطفل، يجب أن تكون النّافذة شديدة العمق، تسمح للطفل بالنّظر خارج المنزل بأمان. في هذه اللحظات، يصبح المعماري فنّانا – حينما يصنع الذّكريات. ولهذا أشدد على جانب الوسائط المتعددة في عملي – رائحة البخور، وأصوات المآذن للصلاة، إلخ.
م.س.: وصلنا لعام ٢٠١١، وتمكنت أخيرا من العودة إلى سوريا بعد الإقامة في الولايات المتحدة فترة كاملة. صاحبها عدد من معارض لمجسّماتك التي توثق زمن مشيك على شوارع دمشق مع مطلع ٢٠١١. هل يمكنك أن تحدثنا عن هذه "اللحظات" التوثيقية، وما تعنيه لك بعد اندلاع الحرب الأهلية في أواخر ٢٠١١؟
م.ح.: توثيقات الحياة في وطني الأم، تأتي من توقي الشّديد له. فبعد ثمانية أعوام أمضيتها في الولايات المتحدة بعد ١١ سبتمبر، حظيت بفرصة زيارة سوريا. حدث ذلك من خلال العمل على مشروع [مع پيكارد چيلتون] تم نصبه في بيروت، لبنان. و لرحلة كانت ستستغرق أسبوعا واحدا، انتهى بي المطاف في سوريا لشهر أثناء انتظار تجديد السفارة لسمة دخولي سوريا (الفيزا) وبغض النظر عن الانتظار، فإنّ هذه الزيارة كانت إحدى أهم ذكريات حياتي. كان بداية ٢٠١١ [قبل الحرب الأهلية]، ولأني تقت توقا شديدا لسوريا، طفت حول الشوارع موثقا صوتيا الأنشطة اليومية.
عندما تضع الأصوات التسجيلية إلى جانب منحوتاتي، فإنها تضيف بعدا آخر – بعدا يجلب هذه التماثيل المصغرة للحياة. أصوات الناس تحديدا تحفز خيالك وتنقلك لعالمهم. حينما ترفع المساجد الأذان وتسمعها، بينما تشاهد تكوينا مصغرا يشبه الواقع لشاعر دمشقي تذكره. يمكن الارتباط بالكثير عندما تشاهد أعمالي، لا يستلزم أن تكون سوريا. المقامات المشتركة حاضرة في قطعي الفنية – نتشارك جميعا بعلاقة شخصية ونقطة مرجعية لذكريات محددة تتعلق بسقسقة الطّيور، والأطفال الذين يلعبون في الأحياء، والموسيقى وحوارات المقاهي، ونداءات أماكن العبادة، إلخ.

الفن، والحرب الأهليّة، وأزمة اللاجئين
م.س.: هلا أسهبت في حديثك عن النقلة المتعلقة بمنهجك الفني عن سوريا من الحنين إلى السعي الحثيث لصنع اضطراب بصري، وتدهور، وهجرة قسرية عاشها سوريّون تعاملوا مأساة حرب مريرة؟ سلسلة أعمالك التعبيرية والشّجية التي كانت بعنوان: تفريغ محتويات: أمتعة لاجئ، تستكشف ما أطلقت عليه تعبير "أمتعة عاطفية" وهي عرض ملموس لإنسانية سحقتها الحرب سحقا. فما الذي تأمل تحقيقه من جهودك؟
م.ح.: هذه السلسلة تعبر عن قصة عشر أسر لاجئة: من السّودان، والعراق، وأفغانستان، وإيران، وسوريا. نحتُّ أمتعتهم، وحاولت عرضت ذكرياتهم بصريا بدءا من موطنهم وانتهاء برحلتهم كلاجئين. دافعي لهكذا مشروع موسّع جاء استجابة لتمييز يؤطر صورة "اللاجئ". عملي الفني يشير إلى حقيقة أنّ أزمة اللاجئين هي أزمة عالميّة. أثّرت على البشر الذي هجروا أوطانهم بسبب الحروب حول العالم، والمعاناة الاقتصادية، والتّغيّر المناخي، وغيرها. وعلى هذا، فإنّ رسم لوحة للقضية بفرشة واحد أمر ظالم. هدفي هو أنسنة "اللاجئ" من خلال قصص جمعية عن أسر لاجئة من خلال مقابلات في الموقع. من هذه المحادثات، استخلصنا صوتا ٩٠ ثانية، وهو متوسط الانتباه الطبيعي، لاستكمال فتح كل حقيبة، وتُعرض أيضا لوحة توجز للقارئ رحلة الأسرة، وما يفعلونه الآن في مكان إقامتهم الجديد. يعمل كثير منهم، أما الآخرون فيستكملون تعليمهم – ولا أحد، كالقصص البليغة السّائدة، تستفيد من أي نظام دولي دون المساهمة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلد المُضيف. بلاغة اللاجئين كشعوب غازية تأخذ وظائف المواطنين زائفة. لا أتحملها، ويجب أن تواجه بحراك نشط وفن.
التّقدير
م.س.: تقديراتك لا يمكن عدّها! تستحقها. ما هو الإنجاز الذي تفخر به من ناحية الجوائز أو التّقدير في أي شكل من أشكاله؟
م.ح.: كما ذكرت، لا تهمني هذه التّكريمات. وأعني بذلك، أنّها لا تؤثر على رغبتي في إنتاج أعمال فنية. في الواقع، أنا أكره الأضواء! لأني أساسا عُرفت بسبب ظروف اضطرارية [الحرب الأهلية السّورية المستمرّة]، ولهذا السبب، تقدير جهودي يبعث شعورا سقيما. ولنفس الأسباب، أنا محظوظ لنيلي هذا التّقدير و للمنصات التي عرضت أعمالي الفنية. لكن بالمجمل، أعتبر عملي واجبا، ومن مسؤوليتي إتقانه. إنّها دنيا فانية، ولا تهمني الأضواء.
الفن باعتباره علاجا
م.س.: هل تقول أنّ ما صنعته فنيّا يعتبر علاجا بالنّسبة لك – يساعدك على تقبل الأزمة السّورية المستمرّة؟ وهل هذا هدف تقصده لمن يستقبل أعمالك الفنيّة؟
م.ح.: عملي علاجي فعلا. في النّهاية، عملي يخصني وحدي. وأنا محظوظ لوجود جمهور يتابعني، وأشخاص يحللون أعمالي. لكني أصنع نماذجي وفني، وقبل كل شيء، لعلاج ذاتي. أنا أكابد لأعيش حياة تستحق العيش، وتبعدني عمّا ينجزه الآخرون. كيف تعيش حياة تستحق العيش لأجلها، قد تسأل نفسك، مع كل المآسي التي تحدث في العالم؟ أولا، يجب أن يعرف المرء متى، وكيف يُنشئ حاجزا رمزيا ومساحة معزولة لأنفسهم، لأفكارهم، لتعبيرات معينة. عزلتي تكون في الأستديو الخاص بي. أشعر بوجود علاج في الوقت الذي أمضى في صنع منحوتاتي المصغّرة. حينما أستذكر هذه التفاصيل المصغّرة التي أنجزتها بعد خمسة أو ستة شهور من العمل المضني، بالكاد أتذكر نصف عملية الصّنع. أي، عندما أصنع فنّا، أكون في حالة تشبه الانتشاء، ودخلت اللاوعي تقريبا، مساحة تخيليّة مريحة.
ملاحظة:
١- عبود، سمير نصيف. سوريا نقاط فعّالة في السّياسة العالميّة. دار بوليتي، ٢٠١٦.
ظهرت نسخة من هذه المقالة في منشور خليجسك ، إصدار سبتمبر ٢٠١٩.
كلمات: ملاك السويحل
الترجمة العربية: دلال نصر الله
الصور: محمـد حافظ